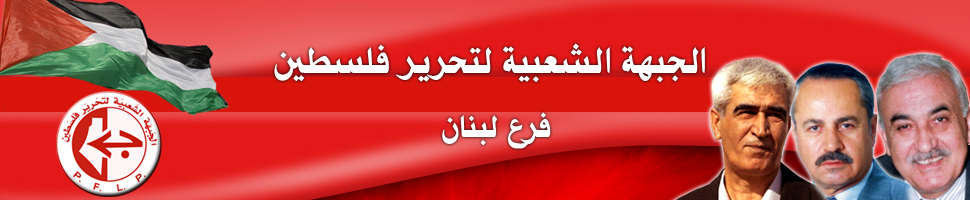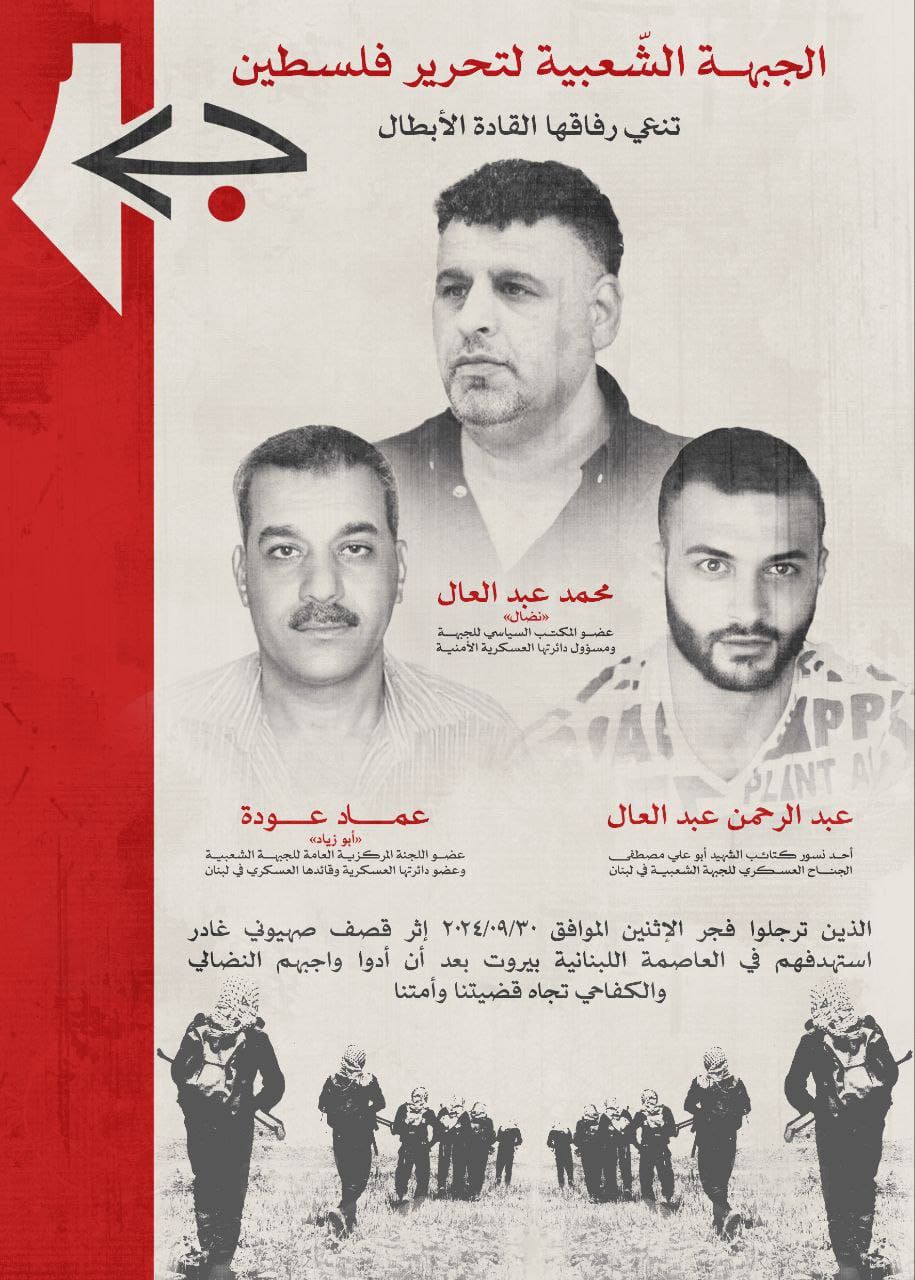بوابة الهدف- د. انتصار الدنان
تهدف هذه الورقة إلى إظهار الفجوة في العلاقات بين المستوطنين أنفسهم، وفشل المشروع الاستيطاني الّذي يدّعيه قادة الاحتلال بأنه معجزة تاريخية اصطنعوها، والمأزق الذي يعيشونه جراء الصّراع الطبقيّ، والعرقي و الطّائفيّ، فعلى الصّعيد الطّبقيّ نرى أنّ هناك فجوة كبيرة بين سكّان المستوطنات الّذين ينقسمون إلى قسميْن، فقراء وأغنياء، فالفقراء الّذين يزدادون فقرًا والأثرياء الّذين يزدادون ثراءً، و الصّراع العرقيّ بين المهاجرين أنفسهم الّذين يتكونون من اليهود المؤسسين، والمهاجرين من أوروبا الغربيّة الّذين اندمجوا اجتماعيًّا مع اليهود المؤسّسين، واليهود المهاجرين من أصول سوفياتيّة ومن أوروبا الغربيّة، الّذين يتوزّعون على المستوطنات الزّراعيّة والتّعاونيّة والموشاف[1]، واليهود الشّرقيين والقلّة القليلة من العرب الّذين أتوا من المغرب العربيّ والعراق ومِصر، وبسبب كل تلك المكوّنات الّتي تعيش في المستوطنات، والتّقسيم على أساس العرق والطّائفة والطّبقيّة، مع مرور الوقت أدّى إلى الشّعور بالتّمييز والطّبقيّة، والطّائفيّة، حيث إنّ المجتمع اليهوديّ ينقسم بين المتدينين والحريديم والعلمانيين، وهذا ما يعمّق الصّراع بين اليهود أنفسهم، ما سيؤدّي في وقت ما إلى انفجار وحصول حرب أهليّة وتأزّم المشروع الاستيطانيّ اليهوديّ، وتقويض حلم إسرائيل في التّمدّد وتحقيق حلمها في إنشاء دولة فلسطين الكبرى من النّيل إلى الفرات.
كما ركّزت هذه الورقة على العوامل التي سوف تؤدي إلى تأزم المشروع الاستيطاني، وقد ظهرت بوادرها بالفعل، حيث إن السكان المتدينين يهدفون إلى توسع المجتمعات الدّينيّة، وهذا التّوسع من المحتمل أن يؤدّي إلى حرب أهلية، فهناك مجتمعان أحدهما منتج يدفع الضّرائب للدّولة، وآخر غير منتج يأخذ من الدّولة، ولا يدفع الضّرائب بحجّة التّفرّغ للدّين، وهذا على صعيد الفقراء والأثرياء، وتقسيم المجتمع على الأساس الطّائفيّ والعرقيّ والطّبقيّ الّذي قسّمناه بين أغنياء وفقراء.
وترى الورقة أنّه خلال السّنوات الثّلاثة القادمة، سيعمل المستوطنون على فرض أنفسهم بالقوّة على مؤسّسات الدّولة، ولن يقبلوا بالمشاركة مع بعضهم البعض، لكنّهم في الوقت نفسه سيواجهون الآخرين. في الوقت الّذي رأيناهم فيه مع تسلّم اليمين الحكومة، بدأوا بالمطالبة بتغيير العقد الاجتماعيّ الّذي صاغه دايفيد بن غوريون مع بداية تأسيس دولة الاحتلال، من خلال صياغة تعديلات قضائيّة، خاصّة تعديلات في المحكمة العليا، حيث ترى قوى اليمين أن المحكمة جزء من اليسار، ولا تتمثّل فيها شرائح المجتمع كلّها بشكل عادل، وهذا الطّرح تم تقديمه بعد انتخاب نتنياهو عام 2002، وتشكيل حكومته من اليمين المتشدد، حيث لاقى هذا الطّرح معارضة شديدة، كونه يسحب من المحكمة قرارات عديدة، وكان نتنياهو قد رفضه أوّلًا ثمّ وافق عليه، فالمتدينون يريدون إعفاء طائفتهم من الخدمة والجيش، وهذا التّعديل قد يوضع على الطّاولة من جديد بعد انتهاء الحرب في غزة، وهناك تمييز بين اليهود من أصول غربيّة وشرقيّة، حيث لا يوجد وزراء شرقيون في الحكومة، كما أنّهم يريدون إضعاف المحكمة بسبب الطّمع في زيادة بناء مستوطنات، والاستيلاء على أراضي الفلسطينيين لإقامة دولتهم المزعومة، حيث إنّ الاستيطان بالنّسبة لهم يرتكز كما يدّعون على أبعاد عدّة في مقدّمها الدين والأسطورة، ويهودا والسّامرة الّتي يبنون عليها أسطورتهم، وتوسعة الاستيطان وتمدّده ووفود مهاجرين جدد إلى المستوطنات قد لا يعود بالإيجابيّة على المستوطنين وعلى دولة الاحتلال. جرّاء كلّ تلك الأسباب، سيؤدي هذا الاستيطان إلى احتراب بين الإسرائيليين أنفسهم، بالإضافة إلى الصّراع الطّبقيّ الّذي باتت ملامحه تظهر بشكل كبير في المجتمع الإسرائيليّ، غير أنّ المستوطنين غير متعلّمين، وفقراء، وليس لديهم حسابات بنكيّة، قياسًا بقادتهم الّذين يعيشون في تل أبيب والمدن الكبرى.
كما يواجه الاستيطان مأزقًا آخر غير الّتي ذكرناها، ومأزقه هو في مقاومة الشّعب الفلسطينيّ اليوميّة، الّذي لم يتوانَ يومًا عن الدّفاع عن أرضه، ويواجه هجمات المستوطنين المحميّون والمدعومين من دولة الاحتلال، حيث تحصل بينهم مواجهات وصلت إلى حد إطلاق النّار على الفلسطينيين من قبل المستوطنين، وضربهم بالحجارة وبالعصيّ، والاعتداء على أملاكهم، وطردهم من أرضهم، ووجود تلك الكتل الاستيطانيّة في الضّفّة الغربيّة يحتاج إلى حماية، لذا، يعمد المستوطنون، وتحت حماية الجيش الإسرائيلي إلى الاعتداء على الفلسطينيين والعمل على طردهم من أراضيهم.
بما أنّ المستوطنين منتجون، فمشروعهم مرتبط بالدّولة، وبالتالي يريدون قيادة الدّولة كلّها نحو مشروعهم كما أشرنا سابقًا، والعلمانيون لا يقتنعون بالمتدينين ويعارضون مشروعهم، و80 بالمائة بحسب مصادر من الإسرائيليين لا يعرفون الضّفّة الغربيّة بسبب وجودهم في المدن، حيث إنّه لا يعرف المستوطنات غير الجنود الّذين يرتبط وجودهم فيها بتأمين الحماية للمستوطنين ليس أكثر، وهذا ما يشجّعهم على طرح مشروعهم بقوّة.
مقدمة:
بعد اتفاقية أوسلو التي تم توقيعها بين منظمة التحرير الفلسطينية ودولة الاحتلال الصّهيوني، الّتي تمّ توقيعها في 13 سبتمبر أيلول عام 1939، وكان قد وقعها الرّئيس الفلسطينيّ الرّاحل ياسر عرفات ، ورئيس الوزراء الإسرائيليّ إسحاق رابين في حديقة البيت الأبيض في واشنطن، وبرعاية أمريكية، الّتي تشكّل “سلطة حكم ذاتيّ فلسطينيّ انتقاليّ” الّذي مهّد لمرحلة جديدة في تاريخ القضيّة الفلسطينيّة، وفي هذا الاتفاق لم يراعِ المفاوض الفلسطينيّ القضايا الأساسيّة في التّفاوض، وعلى رأسها مسألة الاستيطان، فالحكومات الإسرائيليّة المتعاقبة أفردت موازنات كبيرة للنّموّ الاستيطانيّ، بحيث تضاعفت الكتل الاستيطانيّة ثلاثة أضعاف خلال العشرين سنة الّتي تلت اتّفاق أوسلو، وكان الغرض من ذلك اقتطاع أكبر حجم ممكن من جغرافيا الضّفة الغربيّة، لإخراجها من بازار التّفاوض النّهائي مع السّلطة الفلسطينيّة، فالمنطق الّذي حكم المفاوضات حينها، جاء على قاعدة التّفاوض الثّنائي دون مرجعيّات قانونيّة دوليّة، فهناك فرقٌ في ما بين التّفاوض على أراضٍ محتلة وأراضٍ مُتنازع عليها.
وفي دراسة لمنظّمة التّحرير الفلسطينيّة، قالت فيها[2]: إنّ أعداد المستوطنين في الضّفّة الغربيّة تضاعفت سبع مرّات منذ توقيع اتّفاق أوسلو قبل حوالي 30 عامًا، بينما تسيطر المستوطنات على نحو 40 بالمائة من المساحة الإجماليّة للضّفّة الغربيّة، وجاء في تقرير أصدره المكتب الوطني للدّفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التّابع للمنظّمة، أنّ اتّفاقيّة أوسلو تطويها الآن موجات متعاقبة من عمليّات البناء والمخطّطات الاستيطانيّة الّتي تستهدف ما تبقّى للفلسطينيين من أرض، فبعد اتفاق أوسلو عام 1993 واتفاق طابا عام 1995 تم تقسيم الضّفّة الغربيّة إلى ثلاث مناطق، (أ) وهي المدن والبلدات الفلسطينيّة الكبيرة، و(ب) الّتي تضم القرى والبلدات الصّغيرة، و(ج) وهي المساحة الأوسع وتساوي نحو 62 بالمائة من مساحة الضّفةّ الغربيّة، وتخضع إداريًّا وأمنيًّا للسّيطرة الإسرائيليّة الكاملة.
وقد مر الاستيطان بثلاث مراحل:
- المرحلة الأولى: (الأراضي المحتلّة) وهي تُسقط شرعيّة الاستيطان.
- المرحلة الثّانية: (المنطقة المُتنازع عليها منذ عام 1967): في هذه المنطقة، هذا الوجود الاستيطاني يمتلك الشّرعيّة، وفي المحصلة، فإنّ الوجود الاستيطانيّ في الضّفّة الغربيّة نما، وذلك لأسباب مختلفة، فبعد عام 1967، بعد احتلال الضّفّة، قام الاستيطان على تثبيت الاحتلال الّذي امتدّ حتّى توقيع اتّفاقيّة كامب دايفيد إلى اليوم.
- المرحلة الثّالثة: امتدّت بعد اتّفاقيّة كامب دايفيد إلى اليوم.
بعد السّابع من أكتوبر 2023، ازداد المستوطنون اعتداءً على الفلسطينيين، وطردهم من أرضهم، بهدف توسعة الاستيطان، والاستيلاء على الأراضي الفلسطينيّة، تحت ذرائع عديدة، منها الذّريعة الأمنيّة الّتي توفّر الحماية للمستوطنات، والحوافز الّتي تقدّمها حكومة الاحتلال، من إعانات السّكن، وتخفيضات ضريبة الدّخل والمنح المخصّصة لدعم مشاريع الأعمال فيها، والاستثمارات الّتي تضخّها إسرائيل في مشاريع شقّ الطّرق وتأهيل البنى التّحتيّة، وغيرها، غير أنّه وبحسب أحد استطلاعات الرّأي الّتي نشرتها منظّمة السّلام الآن الإسرائيليّ[3]، فإنّه يقطن 77 بالمائة من المستوطنين المستطلعة آراؤهم في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة لأسباب تعود إلى جودة الحياة فيها، وليس لأسباب دينيّة أو أسباب تتعلّق بالأمن القوميّ الإسرائيليّ، ومن الصّعوبة إقناع هؤلاء المستوطنين بترك الأرض إذا ما توافرت لهم الحوافز، وهو السّبب اليوم الّذي يجعلهم ترك الأرض، والقيام بهجرة عكسيّة إلى البلاد الّتي أتوا منها، فبعد معركة طوفان الأقصى لم تعد تتوافر لهم هذه الشّروط، أي شروط بقائهم، هذا عدا نزوحهم من الشّمال بسبب عدم توفر الأمان في المناطق الّتي يسكنونها.
من خلال متابعتنا للحركة الاستيطانيّة تبيّن لنا أنّ حوالي 85 بالمائة من المستوطنين يسكنون حول مدينة القدس ، وفي منطقة غرب رام الله وجنوب غرب نابلس، وذلك بسبب ارتباطهم بمراكز العمل والخدمات داخل “إسرائيل”. يلاحظ أن 70 بالمائة منهم يعملون داخل الخطّ الأخضر، و45 بالمائة داخلها يعملون في الخدمات العامة، وحوالي 34 بالمائة يعملون بالأعمال الزّراعيّة[4] والصّناعيّة، والاستيطان هنا لا يأتي بالمعنى السّكّانيّ، إنّما هو قائم على أساس إحلاليّ، وعبر التّاريخ كانت إسرائيل تعمل على توسعة الاستيطان من خلال الاستيلاء على الأراضي الفلسطينيّة والتّمدّد، وذلك من خلال بناء المستوطنات غير القانونيّة، ويتبنّى معظم المجتمع الدّولي عدم قانونيّة المستوطنات، بما فيه الولايات المتّحدة الأمريكيّة، ويستند في ذلك إلى اتّفاقيّة جنيف 1949 الّتي تحظر نقل قوّة الاحتلال مواطنيها إلى الأراضي المحتلّة، على أنّ الاحتلال يتذرّع ببناء المستوطنات لأسباب عديدة، ومن أهمّ الأسباب الّتي ادّعتها الحكومات الإسرائيليّة بإقامة المستوطنات، منع التّواصل بين الفلسطينيين داخل الضّفّة الغربيّة ومع الأردن تحقيقًا لاستراتيجيّة الإحاطة ثمّ التّغلغل المستقى من المفاهيم العسكريّة، والسّيطرة على موارد الأرض والمياه، وبناء الكسّارات من أجل وضع اليد على المصدر الرّئيس للاقتصاد الفلسطينيّ وهو الحجارة، لكن السّؤال المطروح هنا، ما هي تحدّيات المشروع الاستيطانيّ الإسرائيليّ؟ ومن هي الفئة الّتي تسكن تلك المستوطنات؟ وهل تتجانس في ما بينها؟
بحسب تقرير نشر في صحيفة الشّرق الأوسط[5]، عن دراسة لمجموعة الأبحاث الإسرائيليّة (تمرور)، أشارت فيه إلى أنّ مشروع الاستيطان اليهوديّ في الضّفّة الغربيّة يواجه تحدّيات كبيرة، ويفشل في مواجهة الكثير منها، وبرغم تطرّف المستوطنين سياسيًّا أو أيديولوجيًّا، فإنّنا نجد أنّه يوجد بينهم تراجع عن فكرة الانتقال للاستيطان، حيث إنّه بسبب ذلك سينشأ صراع طبقيّ بين الأثرياء والفقراء الّذين يزدادون فقرًا في الوقت الّذي يزداد الأغنياء غناءً، وبحسب التّقرير، بلغت نسبة الفقر في المستوطنات 10 أضعاف النّسبة في إسرائيل، بالإضافة إلى الصّراع العرقي والطّائفيّ، وكلّ المعطيات الّتي يدّعيها قادة الاستيطان على أنّ الاستيطان هو معجزة تاريخيّة يظهر الواقع عكس ذلك، على أنّه مشروع فاشل برغم كلّ الدّعم الحكوميّ المادّي والعسكريّ والسّياسيّ.
كما يوضّح التّقرير، وبحسب الأرقام الّتي توفّرت له بأنّ 37 بالمائة من النّسبة السّكّانيّة الّتي ارتفعت هي من الحريديم، إلى جانب مستوطنات أخرى تعيش فيها فئة فقيرة، وهذا يعني أنّ أكثر من 40 بالمائة من المستوطنين ينتمون إلى الشّريحة الاقتصاديّة الاجتماعيّة الأدنى الّتي تزداد فقرًا في إطار صراعٍ طبقيّ بين الحريديم والعلمانيين والجمهور المتطرّف المسيحانيّ الصّغير، ما يؤدّي حكمًا إلى أنّ هذه الفئات مجتمعة تتوجه إلى التّغيير الدّيمغرافيّ السّلبيّ.
الإشكاليّة وفرضيّاتها:
ما يثير الانتباه أنّ الاستيطان اليهوديّ، منذ أن وجد على أراضي الضّفّة الغربيّة وحتّى الآن، تشكّل ونما في ظروفٍ تاريخيّةٍ مختلفةٍ، وحمّل بدلالاتٍ ومعانٍ مختلفة، بدءًا من ما قبل النّكبة، مرورًا بالنّكبة وبحرب حزيران 1967، واتّفاقيّة كامب دايفيد لاحقًا، وتبعها اتّفاق أوسلو عام 1993، لكنّ السّؤال المطروح هنا،
- هل هناك حاجة إسرائيليّة فعليّة لهذا الاستيطان؟
- وإذا كان هناك حاجة فعليّة لهذا الاستيطان، فما هي دوافعها؟
من الطّبيعيّ أن يكون هذا الاستيطان جزءًا من السّيطرة على كامل جغرافيا فلسطين، حيث إنّ، أولويّة الحكومة الإسرائيليّة، بحسب المنتدى الإسرائيليّ[6]، من السّماح بإقامة مستوطنات في الضّفّة الغربيّة هي تحقيق الأمن للمستوطنين ولدولة ، حيث يسهم وضع مدنيين إسرائيليين في مناطق معيّنة في تعزيز السّيطرة الإسرائيليّة العسكريّة، تحت ذريعة حماية المستوطنين، لكن السّؤال الأكثر أهمّيّة هو، هل هؤلاء المستوطنين يشكّلون جزءًا لا يتجزّأ من بنية المجتمع الصّهيونيّ؟ أم أنّ الظّاهرة الاستيطانيّة قد ولّدت مجتمعيْن لا يحملان السّمات ذاتها، وقد تتعارض الأدوار فيما بينهما؟
خصّصت إسرائيل مناطق استراتيجيّة معيّنة في الضّفّة الغربيّة للاستيطان اليهوديّ، بينما منعت في البداية إنشاء مجتمعات مدنيّة في المناطق الأكثر اكتظاظًا بالسّكّان، ومن الواضح أنّ الحراك السّياسيّ في هذه الكتل الاستيطانيّة ولّد حضورًا فعليًّا ومؤثّرًا في هيكليّة وبناء النّظام السّياسيّ، وهذا ما نشاهده اليوم من صراعٍ فعليٍّ داخل هذا النّظام، ويتمثّل بقوى مدنيّة ليبراليّة منتجة اقتصاديًّا تعيش في المدن الكبرى، وتمثّلها قوىً سياسيّة علمانيّة. في المقابل هناك جماعات الاستيطان ذات الأيديولوجيّات الدّينيّة غير المنتجة (لا يوجد مصانع ولا أراضٍ زراعيّة) في المستوطنات، ويعتاشون على خزينة الدّولة. صحيح أنّ ما يسمّى بالدّولة العميقة مازالت قادرة حتّى هذا الوقت على بناء لحمة (متوهّمة) بين المستوطنين، لكن هذا الصّراع سيتّخذ أبعادًا مختلفةً في المستقبل، وقد بانت ملامحه في السّنتيْن الأخيرتيْن، لأنّ كلا القوّتيْن لم تعد تحملان مشتركات فيما بينهما، فكلّ قوّة منهما تريد أن تفرض رؤيتها على الدّولة والمجتمع، غير أنّ المشروع الاستيطانيّ في كامل فلسطين هو مشروع واحد، لكنّه في الحقبة التّاريخيّة الأولى حتى عام 1967 أنتج جماعاتٍ مدنيّة، والسّؤال الإشكاليّ هنا،
- هل الجماعات الاستيطانيّة في الضّفّة الغربيّة هي جماعات مدنيّة؟
- هل مثّلت هذه القوّة الاستيطانيّة عوامل استقرارها الدّاخليّ؟
- هل لديها القدرة على فرض رؤيتها على القوى السّياسيّة المدنيّة أم أنّها تشكّل نقطة الضّعف الفعليّة في قلب المشروع الصّهيونيّ؟
للإجابة عن هذه الأسئلة، لا بدّ من التّطرّق إلى الأمور التّالية:
- سمات الظّاهرة الاستيطانيّة في فلسطين المحتلّة.
- خصوصيّة الظّاهرة الاستيطانيّة في فلسطين المحتلّة.
- ثنائيّة الدّاخل- الخارج، الّتي تقوم على أنّ هؤلاء بالقانون الدّوليّ لا يمتلكون شرعيّة قانونيّة دوليّة في امتلاك الراضي، فهم يعيشون على أراضٍ دوليّة، وفي الوقت نفسه تحوّل المستوطنون إلى أن يكونوا أداةً فاعلةً في عصب النّظام السّياسيّ الإسرائيليّ.
- حقيقة الاستيطان، الحجم، الكتلة السّكّانيّة الاستيطانيّة، النّموّ السّكانيّ في المستوطنات، الّذي ارتبط دائمًا بعامليْن أساسييْن (الزّيادة المتأتّية بفعل الولادة، والثّاني بفعل استقدام المهاجرين)، في سياق البحث عن حجم النّموّ الدّيمغرافيّ ومنابعه، لنصل إلى القول بأنّه بين الاستيطان الفعليّ والاستيطان الأيديولوجيّ، وبناء على ما تقدّم، يمكننا طرح السّؤال الإشكاليّ:
- هل هذه الظّاهرة الاستيطانيّة هي جزء لا يتجزّأ من لحمة المشروع أم أنّها جزء من تشظّيه؟ مع الميل إلى أنّ الاستيطان في الضّفّة الغربيّة، وبرغم أنّه ظاهريًّا يؤدّي إلى تماسك المشروع الاستيطانيّ، وتمدّده، ونموّه، غير أنّه، ومن خلال المؤشّرات الظّاهرة أمامنا يقود إلى حتميّة انفجار الصّراع الدّاخلي بين مكوّنات المجتمع الاستيطانيّ ككل.
المنهج المعتمد:
اعتمدْتُ في دراستي هذه غير منهج؛ لأنّ العمل على أي دراسة يتطلّب الاستعانة بغير مِنهج، كما يقول شوقي ضيف:” الباحث الأدبي ينبغي أن يستضيء في عمله بكلّ المناهج والدّراسات السّابقة، إذ لا يكفي مِنهج واحد؛ ولا دراسة واحدة؛ لكي ينهض بعمله على الوجه الأكمل[7]. كما يتطلّب اعتماد ما يُسمّى بالمِنهج العلميّ، وهو الّذي يقوم على التّرصّد والجمع، والمِنهج التّاريخيّ، ثمّ المناقشة والتّحليل للمادّة العلميّة، وعلى المستويات الاقتصاديّة، والاجتماعيّة، والسّياسيّة، والثّقافيّة.
خطّة البحث:
التّعريف بالموضوع، وأهمّيته، ومسوّغات اختياره، وإدراج المراجع الّتي سأعتمد عليها في بحثي، والإشكاليّة وفرضيّاتها، وعن المِنهج المعتمد.
وتوطئة، فيها نبذة مختصرة عن تاريخ الاستيطان، ومراحله، والأهداف منه، حيث سأقسم بحثي إلى ثلاثة مباحث، تتضمّن:
- المبحث الأوّل: مراحل الاستيطان بدءًا ممّا قبل النّكبة حتّى النّكبة.
- المبحث الثّاني: النّموّ الاستيطانيّ بعد النّكبة حتّى عام 1967.
- المبحث الثّالث: تمدّد الاستيطان منذ اتّفاقيّة كامب دايفيد حتّى يومنا هذا.
المبحث الأوّل: مراحل الاستيطان بدءًا ممّا قبل النّكبة حتّى النّكبة.
ظهرت نيّات اليهود بفلسطين عند انعقاد المؤتمر الصّهيونيّ الأوّل عام 1897، وعندما ظهرت المطالبة بدولة يهوديّة في فلسطين.[8] وأثناء الحكم العثمانيّ حاول عدد من قادة الصّهاينة الحصول على وعدٍ بإنشاء وطن قوميّ لليهود، غير أنّ ذلك لم ينجح، واستخدمت الحركة الصّهيونيّة كلّ السّبل لإدخال اليهود إلى فلسطين، فقد دخل بعضهم تجّارًا ورجال أعمال، فيما استغلّ آخرون السّماح لهم بزيارة الأماكن المقدّسة للتّسلّل إلى فلسطين والبقاء فيها.
وتعود بداية الاستيطان اليهودي في فلسطين إلى اللورد موسى مونتفيوري الّذي نجح في الحصول على الموافقة العثمانية لشراء عدة قطع من الأراضي بالقرب من القدس ويافا، وبدأ البناء على مساحة من الأرض خارج أسوار القدس عام 1859 لتكون حيًّا لليهود سُمي باسمه، ثم تمكّن من بناء سبعة أحياء أخرى حتّى سنة [9]1892.
استمرّ عدد المستوطنين في التّزايد طوال العهد العثماني، ففي عام 1882 كان عدد اليهود في فلسطين 24 ألف يهودي، وقفز في عام 1917 إلى أكثر من 85 ألف يهودي بعد الحرب العالميّة الأولى حيث فكّر بن غوريون تجنيد عشرة آلاف متطوّع يهوديّ للاشتراك في الحرب على تراب فلسطين إلى جانب الأتراك، من أجل السّماح لليهود بالهجرة والاستيطان، وكذلك زادت أعداد المستوطَنات، ففي حين كان عددها عام 1884 خمس مستوطنات، صارت 47 مستوطنة عام 1914.
مع وقوع فلسطين تحت الانتداب البريطانيّ، بدأت حقبة جديدة في تاريخ الاستيطان، فبتاريخ 2 تشرين الثّاني\ نوفمبر 1917 صدر وعد بلفور الّذي يدعو إلى قيام وطنٍ قوميٍّ لليهود في فلسطين، ما أدى إلى سنّ قوانين خاصّة بفتح أبواب الهجرة، وتسهيل انتقال الأراضي إلى الحركة الصّهيونيّة، وحماية الاستيطان بقوّة السّلاح، وبين عاميّ 1918 و1949 تضاعف عدد اليهود، وبُنيت العديد من المستوطنات في أرجاء فلسطين إلى أن بلغ عددها 169 مستوطنة، وقد كان تركيز المستوطنات على السّاحل الفلسطيني بشكل أساسيٍّ.
لم تتوقّف الدّعوات المتكرّرة لتوطين اليهود في فلسطين، ورعت هذه الدّعوات دول وأنظمة أوروبيّة من أهمّها الدّعوات الّتي قادتها بريطانيا[10]، والّتي نتج عنها إقناع الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة بأن تصدر في 29 تشرين الثّاني\ نوفمبر 1947 القرار رقم (181)، الّذي نصّ بتقسيم فلسطين وإعطاء 55 بالمائة من مساحة فلسطين لليهود، ونظرًا إلى رفض العرب ذلك الأمر، والشّعور بالظّلم والإجحاف بحقهم، وعدم رضا المنظّمات الصّهيونيّة بالنّسبة الّتي أعطيت لهم، اندلعت حرب عام 1948، الّتي حصلت بين المقاومة الفلسطينيّة والجيوش العربيّة والمنظّمات الصّهيونيّة المسلّحة المدعومة من حكومة الانتداب البريطانيّة، ما أدى إلى تهجير أعداد كبيرة الفلسطينيين من أرضهم، بعد مجازر قامت بها المنظّمات الصهيونية بحق الفلسطينيين، و استيلاء الحركة الصّهيونيّة على الأراضي الفلسطينيّة، ما أدى إلى اتّساع رقعة “إسرائيل إلى” 22920000 دونم، هذا عدا عن المسطّحات المائيّة الّتي تبلغ 425 دونمًا.
يتركّز الحيّز الجغرافي الاستيطانيّ للمستوطنين في القدس، حيث يشكّل أعلى نسبة من المستوطنين، والّتي تبلغ حوالي النّصف، وما يشكّل نسبته ربع الاستيطان موجود على حدود الخطّ الأخضر أو أكثر، والكتلة الاستيطانيّة الأخرى موجودة في قلب الضّفّة اّلتي تبلغ مساحتها 8860 كلم مربع، وتبلغ نسبة المستوطنات حوالي 2000 كلم مربع، ما يعني أن مساحة المستوطنات بالضّفة تبلغ واحد ونصف بالمائة، والنّموّ الاستيطانيّ الطّبيعيّ للسّكان أو العمران هو نموّ طبيعيّ، من نسبة السكان المهاجرين، والتّمدّد الجغرافيّ والعمرانيّ لا يعني البشر، وهذا يعني تفكيك مقولة المليون مستوطن في الضّفّة الغربيّة، لأنّ نصف المستوطنين يعيشون في الحيز الجغرافيّ في القدس، ما يدلّ على أنّ تأثيرهم على الضّفة تأثيرٌ محدودٌ.
الأطماع الصّهيونيّة في احتلال المزيد من الأراضي لم تتوقّف عند هذا الحدّ، فشنّت حربًا جديدة في الخامس من حزيران 1967، فاحتلّت كامل فلسطين، وشبه جزيرة سيناء، والجولان السّوريّ، بحسب خطّة كانت قد أعدّتها حكومة الاحتلال لتحقيق حلمها في إقامة دولة إسرائيل من الفرات إلى النّيل.
المبحث الثّاني: النّموّ الاستيطانيّ منذ النّكبة حتّى عام 1967
قبل احتلال الصهاينة لأراضي فلسطين، كان يعيش في فلسطين سبعمائة ألف يهودي، ويمكن تقسيمهم إلى أربع فئات[11]:
الفئة الأولى: هم اليهود الّذين استوطنوا فلسطين لأكثر من عشرين عامًا قبل التّقدم بقضيّة قرار تقسيم فلسطين إلى الأمم المتّحدة عام 1947.
الفئة الثّانية: هم أولئك الّذين سكنوا فلسطين بحسب قانون الانتداب الّذي وضع أنظمة الهجرة وبموجبه صاروا مواطنين فلسطينيين.
الفئة الثّالثة: هم أولئك الّذين دخلوا بحسب قوانين الهجرة، لكنّهم لم يصيروا مواطنين.
الفئة الرّابعة: هم الّذين دخلوا فلسطين بصورة غير مشروعة.
بحسب كتاب الإحصاء البريطانيّ الرّسميّ لم يكن في عام 1947 في فلسطين إلّا 250 ألف يهوديّ يحملون الجنسيّة الفلسطينيّة، وفيما عدا هؤلاء فجميع اليهود، أي 450 ألف يهوديّ معظمهم دخل فلسطين بشكلٍ غير مشروع، وجميعهم لا يحملون الجنسيّة الفلسطينيّة.
لم يصل الاستيطان إلى الضّفّة الغربيّة قبل عام 1967، لكن هذا لا يعني أنّه لم تكن هناك محاولات استيطان من قبل الإسرائيليين، خاصّة، بعد أنّ شرّع الانتداب البريطانيّ لهم ذلك، وبعد أن كان الحصول على الأراضي عن طريق الشّراء بطريقة غير قانونيّة في المجمل أثناء الحكم العثمانيّ، أو تسريبها عن طريق المنح أو البيع أو الإيجار أثناء الحكم البريطانيّ، صارت تحت القوّة العسكريّة بعد النّكبة عام 1948، وقيام دولة “إسرائيل” بشكل رسميّ، والاستيلاء على الأراضي وطرد أهلها منها[12].
بداية، كان تركيز المستوطنات على السّاحل الفلسطينيّ بشكل أساسيّ، ثمّ في مرج بن عامر والجليل الأعلى والأدنى والنّقب، لكن بنسبة أقل مما هي عليه في السّاحل الفلسطينيّ، وهي المنطقة الّتي شكّلت حدود دولة “إسرائيل” عام 1948، ما أدى إلى التّوسّع من حيث المساحة والعدد للاستيطان المستمرّ والمتّصل جغرافيًّا، بناء على تقسيم فلسطين عام 1947 في الأمم المتّحدة الّتي أعطت لليهود 55% من أراضي فلسطين وفقًا للقرار 181.
بعد حرب حزيران 1967، دارت مناقشات بين كلّ القوّى، والجماعات السّياسيّة والفكريّة الإسرائيليّة حول موضوع الاستيطان، وإمكانيّة التّمدّد، إلى أن تمخض عن المشاورات استيطان أكبر قدر ممكن من الأراضي الفلسطينيّة، وباشر بعدها السّياسيّون الإسرائيليّون والحكومات بإصدار المشاريع الاستيطانيّة، وكان ذلك وفق مخطّط قد خطّط له السّياسيّون الصّهاينة قبل حرب حزيران 1967، ما يعني أن “إسرائيل” تسعى وراء تحقيق حلمها، وهو تأسيس دولة “إسرائيل الكبرى” الممتدّة من النّيل إلى الفرات.
المبحث الثّالث: تمدّد الاستيطان منذ اتّفاقيّة كامب دايفيد حتّى يومنا هذا
منذ عام 1967 بدأ الاستيطان في الضّفة الغربيّة يتمدّد، ومازال إلى الآن. بعد معركة طوفان الأقصى صار يتمدّد أكثر، وذلك وفقًا لتقارير حقوقيّة أكدت أنّه تم تسجيل 133 عملية هدم سُجّلت في القدس، منذ بداية الحرب حتّى منتصف شهر آذار، و97 من المنشآت الّتي هُدمت كانت عبارة عن وحدات سكنيّة.
من الواضح ارتفاع معدّل هدم منازل المقدسيين، من قبل سلطات الاحتلال، بادّعاء بنائها دون ترخيص، للاستيلاء عليها في وقت لاحق للمستوطنين، لكن السّؤال المطروح هنا، أي شريحة من المستوطنين تسكن هذه المستوطنات؟ وأي شريحة سياسيّة؟ هل هم شرقيين أم غربيين؟ وعلى ماذا يعتمد التّوسع الاستيطانيّ في الضّفة؟ وما شكل تماسك الوحدة الاستيطانيّة؟ وهل مجتمعات المستوطنين متجانسة فيما بينها؟
عندما احتلت إسرائيل الضّفّة الغربيّة وقطاع غزّة في العام 1967، لم يكن هناك تسجيل رسميّ إلا لثلث الأراضي المملوكة للفلسطينيين، فيما كانت بقيّة الأراضي مثبتة ملكيّتها من خلال كواشين، وشهادات تسجيل رسميّة صادرة عن حكومة الانتداب البريطانيّ، وكذلك التّسجيل لدى دائرة الأراضي الأردنيّة بحسب القانون المعمول به قبل العام 1967 بشكلٍ أساسيٍّ[13].
منذ عام 1967 تسعى إسرائيل نقل عدد من سكّانها المدنيين إلى الضّفّة الغربيّة وقطاع غزّة، بهدف توسيع رقعتها الاستيطانيّة، وهذا الأمر هو مخالف للقوانين الدّوليّة، ومن بين هؤلاء المستوطنين يسكن ما يزيد على مليون مستوطن إسرائيلي في المستوطنات المقامة في الضّفّة الغربيّة، وما يزيد على 190000 مستوطن في القدس الشّرقيّة، وفي المناطق المحيطة بها[14]. وتتفاوت المستوطنات الإسرائيلية في حجمها بين مستوطناتٍ وليدةٍ أو “بؤرٍ” استيطانية تتألف من عدد قليل من البيوت المتنقلة، ومستوطنات تشكّل مدنًا كاملةً تؤوي عشرات الآلاف من المستوطنين. وتتمثّل الغاية من المشاريع الاستيطانيّة الّتي تقوم بتنفيذها إسرائيل تغيير وضع الأراضي الفلسطينية المحتلة للنّاحيتيْن المادية والديموغرافية، بهدف الحيلولة دون عودة الفلسطينيين إليها، وإمكانيّة حلّ الدّولتيْن، وفي الوقت نفسه وضع يدها على الأراضي الفلسطينيّة والموارد الطبيعية بصورةٍ غير قانونية، وعزل الفلسطينيين في أماكن تمنعهم من البقاء، وتشهد تقلّصًا متواصلًا في مساحتها، هذا عدا عن فصل القدس الشرقية عن بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي عام 1977، بعد اعتلاء حزب الليكود الحكم، وفق بتساليم، ازداد بناء المستوطنات في جميع أنحاء الضّفّة الغربيّة، خاصّة في المناطق بين رام الله ونابلس، وشمالي الضّفّة، وذلك، وبحسب الاحتلال، بدوافع أمنيّة واستراتيجيّة.
وبحسب مصادر إسرائيليّة، فإن إسرائيل وعلى مدى سنوات، سعت من خلال الاستيطان إلى ضمان تحقيق الأمن للبلاد، من وضع جنود على حدود المستوطنات لتأمين حمايتها، وأن يكون المستوطنون بمثابة خطّ الدّفاع الأوّل ضدّ أي اعتداء على إسرائيل.
إنّ إبرام اتّفاقيّة كامب دايفيد بين الرّئيس أنور السّادات ورئيس وزراء الكيان الصّهيونيّ مناحيم بيجن عام 1978، أهدر الحقوق الثّابتة للشّعب الفلسطينيّ، الّتي أقرّتها المواثيق الدّوليّة، وأدى إلى منح سكّان غزّة والقطاع سلطة إداريّة محدودة لا تفضي بأيّ حالٍ من الأحوال إلى إقامة الدّولة الفلسطينيّة، ومواجهة التّهويد ومشاريع السّيطرة الصّهيونيّة، وعمل الكيان الصّهيونيّ على مصادرة مساحات واسعة من الأراضي الخصبة المزروعة بالخضراوات والنّخيل، حيث سيطر على ما يقرب من ثلث مساحة قطاع غزّة في الفترة الممتدّة ما بين اتّفاقيّة كامب دايفيد واتّفاقيّة أوسلو عام 1993، حيث إنّه لم تتوقّف جهود الكيان الصّهيونيّ في تدمير القطاع الزّراعي وربطه بالاقتصاد الإسرائيليّ[15]، ولم تقتصر إجراءات الاحتلال على الجانب الزّراعيّ فقط، بل تعدّته إلى الجانب الصّناعيّ، حيث عملت سلطات الاحتلال على تدمير البنية الصّناعيّة للاقتصاد الوطنيّ الفلسطينيّ وربطه باقتصاد الكيان، وجعله تابعًا له، من خلال إجراءات عديدة ساهمت في إضعاف البنيّة الاقتصاديّة لسكّان الضّفّة وقطاع غزّة.
منذ اتّفاق أوسلو، ازداد الاستيطان بشكل أكبر، وواصلت سلطات الاحتلال مصادرة أراضي الفلسطينيين، تحت حجج وذرائع أمنية، وبحسب مصادر، فقد بلغت مساحة الأراضي التي تمت مصادرتها بعد اتّفاق أوسلو، في الضّفّة نحو 67 ألف دونم، وبلغت نسبة أراضي الضّفّة الّتي أعلنتها سلطات الاحتلال 70% تقريبًا من مجموع مساحة الضّفّة[16]. أمّا بحسب مصادر السّلطة الفلسطينيّة، فقد بلغت مساحة الأراضي المصادرة بعد اتفاق أوسلو حتى تشرين الأول\ أكتوبر 1994، حوالي 70 ألف دونم، خصّص منها 10 آلاف دونم لتوسعة المستوطنات.
وقد تمّ تقسيم الضفة الغربية بعد التوقيع على اتفاق طابا 1995 إلى ثلاث مناطق (أ) وهي المدن والقرى الفلسطينية الكبيرة، و(ب) وهي التي تضم القرى والبلدات الصغيرة، و(ج)، وهي المساحة الأوسع وتساوي حوالي 62 بالمائة من مساحة الضفة الغربية، وتخضع إداريًّا وأمنيًّا للسّيطرة الإسرائيليّة الكاملة.
المنطقة (ج) كانت محط أطماع دولة الاحتلال، كونها المجال الحيوي لمشروع توسع الاستيطان، وما نسبته 99 % محظور على الفلسطينيين استخدامها، ولا تسمح سلطات الاحتلال للفلسطينيين بالبناء فيها لأغراض السكن أو لأي أغراض أخرى، كالأغراض التّجاريّة أو الصّناعيّة، فهذه الأرض فيها معظم الموارد الطّبيعيّة في الضّفّة الغربيّة، وفيها أحواض المياه الرّئيسة، باستثناء الحوض الشّمالي الشّرقي في محافظة جنين وفيها المساحات المفتوحة[17] الّتي كانت دخل المزارعين الفلسطينيين.
بعد اتفاق أوسلو حصلت موجتان استيطانيتان كبيرتان، الأولى حصلت بعد التوقيع مباشرة، حيث بدأ العمل على التّوسّع الاستيطانيّ، وتجريف الأراضي وشق الشّوارع الالتفافيّة، وإصدار الأوامر القضائيّة بوضع اليد على الأراضي الفلسطينيّة، خلافًا لاتفاقيّة أوسلو الّتي نصّت على أنّه لا يجوز لكلا الطّرفين اتخاذ أي خطوة من شأنها تغيير الوضع في الضّفّة وقطاع غزة لحين معرفة نتائج مفاوضات الوضع النّهائيّ.
على الدّوام كانت إسرائيل تنجح في رفع أعداد المستوطنات، حيث وصل عدد المستوطنات عام 2022 في الضفة إلى 158 مستوطنة بما فيها القدس الشّرقيّة الّتي يسكنها حوالي 750 مستوطنًا.
أمّا الموجة الثّانية، فقد بدأت مع صعود اليمين الإسرائيليّ المتطرّف إلى الحكم بعد الانتخابات الأخيرة للكنيست عام 2022، الّتي تهدف إلى رفع عدد المستوطنين في الضّفّة الغربيّة، بما فيها القدس الشّرقيّة إلى نحو مليون مستوطن في السّنتين القادمتين.
بعد أحداث السّابع من أكتوبر 2023، استغلّ المستوطنون حالة الحرب، وعمدوا من خلال تسليحهم الّذي سهّل له الوزير اليمينيّ المتطرّف إتمار بن غفير، إلى الاعتداء على الفلسطينيين وعلى البدو ورعاة الأغنام، وتهجير البدو، والاستيلاء على مساحات كبيرة من الأراضي في الأغوار، حيث تسارعت في المدّة الأخيرة هجمات المستوطنين على التّجمّعات الرّعويّة والبدويّة بمساندة من الجيش الإسرائيليّ والشّرطة، كما يقومون بمصادرة أملاك التّجمّعات، وقد تمكّن المستوطنون بفعل هذه الإجراءات من تهجير عشرات الأسرالفلسطينية الّتي تقيم في منطقة الأغوار، كما تمّ تهجير جميع البدو والرّعاة الّذين يسكنون في مناطق سامية، ورأس التّين، والتّبون وغيرها[18]، وكلّ ذلك، وبحسب الاحتلال يحدث، لضمان الاستقرار الأمنيّ ضدّ أي مشاركة لسكان الأغوار في المقاومة، وتهجير التّجمّعات البدويّة والرّعويّة، لإجراء التّرتيبات الدّيمغرافيّة الّتي تتوافق مع فكرة الضمّ.
بعد ما أورته سابقًا، أستطيع القول إن حجم الاستيطان في الضّفّة الغربيّة ليس قائمًا على المستوطنين فقط، إنّما من خلال العمران أيضًا، أي من خلال التّوسع في البناء، حيث إنّه من خلال اطّلاعي، تبيّن معي أنّ نسبة المستوطنين الّذين يكنون في المستوطنات تتفاوت النّسب بينهم، ما يعني أنّ الكتل السّكانيّة قويّة في مكان ما على حساب مستوطنات أخرى نسبة السّكان فيها قليلة.
إنّ تماسك الوحدة الاستيطانيّة بالضّفّة ليس مبنيًّا على قوّة ذاتيّة، إنّما هي مرتبطة بوجود جيش الاحتلال الموجود حول الحيّز الاستيطانيّ.
وهنا أستطيع أن أطرح الإشكاليّة الّتي تتمثّل، بالتّالي:
- هذه الجماعات الاستيطانيّة، ماذا تريد؟ هي تريد أن تحكم الجيش والدّولة، وهنا يقع المأزق، وهو الاحتراب أو اللّحمة، وهنا لا أقول حربًا أهليّة ضد بعضهم، لأنّ ذلك مرتبط بإمكانيّاتهم، وعددهم، وتأثيرهم السّياسيّ والاقتصاديّ، وهم بالطّبع، إمكانيّاتهم لا تسمح، فإذًا، هنا سيستخدمون أداة توظيف من قبل القوّة السّياسيّة في إسرائيل، أي الحكومة، ما يعني أداة وطبقيّة، و هم ليسوا جزءًا أصيلًا من المكوّن السّياسيّ.
- فإذًا، الاحتراب يأتي من خلال وهم يغذّيه مسؤولون في الحكومة الإسرائيليّة، وهم مستوطنون، على أن يكون وزيرًا في الحكومة، وزيرًا لكل البلد، فعلى سبيل المثال، الوزير بتسلئيل سموتريش، عبر سياساته الماليّة يدعم الاستيطان بقوّة، ويعمل على ذلك، من خلال موقعه السياسي في الوزارة الماليّة، من خلال خطة الحسم التي يستخدمها، وهي تسهيل الاستيطان.
- النّقطة الأهم لمشروع الاستيطان الّذي تريده الدّولة والقوّة السّياسيّة هي الأداة التّنفيذيّة لهذا المشروع، فعلى ماذا يقوم التّشريع القانونيّ عندهم للاستيطان؟
المهم ذكره هنا، أنّه، وبحسب القانون الدّوليّ، فإنّ الضّفّة الغربيّة تقع تحت الاحتلال، ومع هذا يجبر أهلها على تركها بالقوّة، وتحت عدد من الذّرائع، منها:
- إيجاد حيّزٍ أمنيًّ للمستوطنات، ما يعني أنّه لأسباب أمنيّة يستولون على الأراضي الفلسطينيّة، وبناء منطقة عسكريّة جغرافيّتها مفتوحة، ما تشكل دائرة كبيرة حول المستوطنة، فإذًا، وبحسب زعمهم المصادرة هي لأسباب أمنيّة.
- الاستيطان في الأراضي الفلسطينيّة في الضّفّة نوعان:
- الأراضي الخاصّة، وهي ملك للفلسطينيين موثّقة بـ(الطّابو)[19].
- الأراضي الأميريّة أو المشاع، وهي ملك لدولة فلسطين، وبما أنّهم يتعاطون مع هذه الأراضي في الضّفّة الغربية على أنّها أرض متنازع عليها، فمعظم الاستيطان في الأراضي الأميرية، بعد مصادرتها، حيث باتت نصف الضّفّة الغربيّة مصادرة، فقد صادروا الجبال كلّها تقريبًا، ومفتاح المصادرة يأتي من باب الزّاوية الأمنيّة.
هذا المشروع اليوم، أي مشروع الاستيطان، يقدم نفسه هديّة الدّولة كلّها، كمشروع سياسيّ واقتصاديّ وحلّ النّزاع بطريقتهم، ويعتبرون بأنّهم سيسيرون بمشروعهم الاستيطانيّ، ومن سيقاوم هذا الاستيطانيّ من الفلسطينيين سيُقتل، ومن لا يعجبه الأمر من الفلسطينيين فليرحل، وإذا رغب بالبقاء في أرضه، فليبق، لكن بشرط أن يبقى عبدًا عندهم عاملًا في المصنع.
الخلاصة:
منذ عام 1967 حتّى الآن، مرّ الاستيطان بثلاث محطّات:
- من النّكسة إلى اتّفاق كامب دايفيد كان الاستيطان صغيرًا بسيطًا.
- بعد اتّفاق كامب دايفيد كان هناك نهضة شرسة من التّمدّد الاستيطانيّ لم يكن مهولًا حتّى اتّفاق أوسلو.
- منذ العام 1967 حتى اتّفاق أوسلو عام 1993 إلى اليوم تضاعف الاستيطان ثلاث مرّات.
فهناك 15% من مساحة الضّفّة المصادرة في الأغوار، حيث إنّ 4 بالمائة من الأراضي الزّراعيّة في الأغوار، في الأغوار حيث الاستيطان الحقيقيّ، حيث إن ما تنتجه الأراضي الزّراعيّة تقدّر بمليارات الدّولارات، وعليه، فإن الاستيطان المنتج موجود في أراضٍ زراعيّة منتجة، فمشاريع التّمور على سبيل المثال تنتج من مليار دولار إلى مليار ونصف، هذا عدا عن مشاريع الخضراوات الّتي بدورها تدرّ مبالغ كبيرة للاقتصاد الإسرائيليّ.
- هؤلاء المستوطنون، وبما أنّهم منتجون، فمشروعهم مرتبط بالدّولة، ويريدون قيادة الدّولة كلّها نحو مشروعهم، وهذا تتم ترجمته على الأرض، ما يعني أنّهم يريدون قهر الإسرائيليين أنفسهم، فجزء من فكرة الاستيطان هو جزء ديني أسطوري، أما العلمانيّون لا يقتنعون بهم، و80 % من الإسرائيليين لا يعرفون الضّفّة الغربيّة، فقط الجنود يعرفونها، لأنّهم يعيشون فيها بسبب حماية المستوطنين الموجودين هناك.
فإذًا، كلّ المشروع الاستيطانيّ الإحلاليّ هو فكرة غربيّة، وعُمل عليه عبر التّاريخ، وكلّ المشاريع الاستيطانيّة التي مرّ بها التّاريخ، وفي قرون مضت انتهت وزالت، لم تنجح فيها مشاريع الاحتلال، ففي الجزائر على سبيل، لم يستطع الاحتلال البقاء في أرضها، حيث إنّها طردت 2 مليون مستوطن فرنسي بعد قرن من الزّمن واستقلت، وكذلك جنوب أفريقيا، ونامبيا.
- الشّعب الفلسطينيّ بعد قرنٍ من النّضال إلى الآن لم يرفع الرّاية البيضاء، وما زال يناضل حتّى اللّحظة، وما معركة طوفان الأقصى إلا دليلٌ على ذلك، وانتفاضة الأقصى عام 2002 هي دليل على مطاردة الفلسطيني في كل مكان، وقد حصلت انتفاضة الأقصى عام 2002 بعد أن اقتحم زعيم المعارضة الإسرائيليّة أرييل شارون باحات المسجد الأقصى تحت حماية حوالي 2000 جندي ومن القوات الخاصّة، بموافقة رئيس الوزراء حينها إيهود باراك، فوقعت مواجهات بين المصلّين وقوات الاحتلال، انتهى الأمر بالإسرائيليين بضم أراض وبناء جدار فصل عازل الّذي اعتبرته محكمة العدل في لاهاي بعدم قانونيّته، وطالبت إسرائيل بوقف بنائه، غير أنّ إسرائيل لم تتوقّف عن ذلك، وعليه، فهم يطاردون الفلسطينيين في كل مكان، فمأزق الاستيطان إذًا، هو في مقاومة الشّعب الفلسطينيّ، ووجود تلك الكتلة الاستيطانية في الضّفّة تحتاج إلى حماية، لذا، يعمد المستوطنون وتحت حماية الجيش الإسرائيلي للاستيلاء على أراضي الفلسطينيين وطردهم منها.
- من المحتمل أن يؤدّي توسّع الاستيطان إلى حرب أهليّة، فبكل بساطة المستوطنون يريدون أن يأخذوا كلّ مقدّرات الدّولة، فالمجتمعات الدّينيّة هي ضد المستوطنين الّذين يعيشون في تلك المستوطنات، فهناك مجتمعان واحد منتج يدفع ضرائب للدّولة، وآخر غير منتج يأخذ من الدّولة ولا يدفع ضرائب بحجة التّفرغ للدّين، بالإضافة إلى التّقسيم العرقي والطّائفيّ، والمشروع الاستيطاني خلال السّنوات الثّلاثة القادمة، سيفرض فيه المستوطنون أنفسهم بالقوّة على مؤسّسات الدّولة، ولن يقبلوا المشاركة مع غيرهم، لكنّهم في الوقت نفسه يواجهون قوتيْن، القوّة الأولى، مقاومة الشّعب الفلسطينيّ، والمقاومة الثّانية، هي مواجهة الكتلة الفاعلة لدولة إسرائيل.
- المستوطنون غير متعلّمين، وهم فقراء، وليس عندهم أرصدة في البنوك، قياسًا بقادتهم الّذين يقطنون المدن الكبرى، في تلّ أبيب وحيفا، وقادتهم أيديولجيون وغير سياسيين.
غير أنّ العقد الاجتماعيّ الّذي صاغه للدّولة دايفيد بن غوريون، ومازال ساريًا إلى اليوم، لا يتماشى مع طموحات المتدينين، والمستوطنون والصّهيونيّة الدّينيّة يريدون صياغة عقد جديد، وقد أتى ذلك واضحًا بعد أن طالب وزير العدل الإسرائيلي من نتنياهو إجراء تعديلات قضائيّة، الّتي من مهامها نزع كل إمكانياتهم لصالح المستوطنين.
بعد انتهاء حرب غزة، إذا طُرح موضوع الإصلاح القضائيّ من جديد، الّذي يعبّر عن قرار المستوطنين وطموحاتهم، سيلاقي مواجهة وعنف في الشّارع، وإذا لم يُطرح، فمشروع الاستيطان سيتوقف، فجميعهم لا يستطيعون صياغة عقد اجتماعيّ جديد، وعدم صياغة عقد اجتماعيّ جديد يعني بداية انهيار هذا المشروع.
الاستنتاجات:
على الرّغم من الحوافز الّتي نجحت حكومة الاحتلال في تقديمها للمستوطنين، الأمر الّذي أدى إلى استقطاب الآلاف من المستوطنين اليهود، وتشجيعهم على السّكن في المستوطنات الّتي تقيمها سلطة الاحتلال في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة، ما يؤدّي إلى جذبهم إلى السّكن في المستوطنات، وذلك لأسباب عديدة، منها أسباب دينيّة، لاعتقادهم أنّ الله أعطى هذه الأرض لليهود، كما أن الحياة أرخص بكثير منها في المدن الكبرى، لكن يتبيّن لنا، أنّه وبالرّغم من تماسك اليهود الّذين استوطنوا الأراضي الفلسطينيّة، غير أنّ الواقع يظهر عكس ذلك، فالمستوطنون المهاجرون هم من فئات وبيئات مختلفة، فهم من يهود الفلاشا وأفريقيا والمغرب العربيّ، وهؤلاء يعيشون في منطقة اللواء الجنوبي الصّحراوي، ويعملون بالأعمال اليدويّة كالزّراعة والحرفيّة، بينما يهود أوروبا الشّرقيّة يستوطنون الشّمال، وذلك، بما يخدم طبيعة عملهم، حيث يسكنون في المناطق الكبرى، كعكا وحيفا ونهاريا، ويوفر لهم سكنًا منخفض التّكاليف، بينما يستوطن اليهود المتدينون “الحريديم” أحياء القدس، وبني براك، وبيت شميش، لكنّهم يتقوقعون على أنفسهم، وبعيدًا عن المجتمع العلمانيّ في السّاحل وتل أبيب، بالقرب من الامتيازات الّتي تقدّمها الحكومة، والمدارس اليهوديّة الدّينيّة في القدس.
هذا التّقسيم الطّبقيّ سيؤدّي بطبيعة الحال إلى صراع طبقيّ، عرقيّ، وطائفيّ، حيث إنّ المجتمع الإسرائيليّ مبنيُّ على المهاجرين، فالصّراع العرقيّ هو بين اليهود الشّرقيين والمهاجرين الأوروبيين، أما الصّراع الطّبقيّ فهو بين الفقراء والأغنياء، والطّائفيّ بين المتدينين والحريديم والعلمانيين.
الصّراع الطّائفيّ يظهر جليًّا بين المستوطنين اليهود، حيث ينقسم المجتمع اليهوديّ في لواء الشّمال وحيفا إلى قسميْن، مهاجرين ومؤسّسين. المؤسّسون هم اليهود الّذين أتوا إلى فلسطين في مرحلة الانتداب، ويتمركزون في تسعة تجمّعات استيطانيّة، اختلط معظمهم اجتماعيًّا مع سكّان أوروبا الغربيّة، والمهاجرون هم يتوزّعون على المستوطنات الجماهيريّة والزّراعيّة والتّعاونيّة والموشاف، وهم من أصول سوفياتيّة وأوروبا الشّرقيّة، كما القلّة القليلة من اليهود الشّرقيين (العرب) الّذين أتوا من المغرب العربيّ والعراق ومصر. هذا المزيج أدى بالشّعور إلى التّمييز والتّفرقة والطّبقيّة والعنصريّة، مرورًا بالوضع المعيشيّ والتّعليميّ، ومستوى الدّخل المتدنّي لمستوطني الشّمال، غير أنّ نسب الفقر ترتفع بين العائلات اليهوديّة في الشّمال، والمستوى الأكاديميّ العام المنخفض مقارنة بالوسط والمركز ما ينذر بوجود فجوة طبقيّة، وبحسب التّصنيف للحالة الاقتصاديّة والاجتماعيّة لمستوطني الاحتلال، بحسب تقارير، فهي 44 بالمائة يحصلون على أدنى الأجور، و23 بالمائة يحصلون على أجور أعلى من الحد الأدنى ما يحوّلها إلى مستوطنات غنيّة إلى ميسورة تعتاش على الأعمال الموسميّة الّتي لا تحمي من الفقر، فهم يعملون بالزّراعة، والسّياحة، وتنشيط المزارات الدّينيّة والبيئيّة، كما أنّ المستوى التّعليميّ للمستوطنين في الشمال منخفض أكثر منه في الجنوب، ما يؤدّي إلى تعميق انقساماتها وتظهيرها، وانكشاف فئاته وصراعاته على بعضها البعض، بالإضافة إلى التّعديلات القضائيّة الّتي يسعى إليها التّيّار الدّينيّ خدمة لمصالحه الخاصّة، وعليه، هل نستطيع اعتبار بناء المستوطنات وتمدّدها يأتي لمصلحة الكيان أم أنّه سيجد نفسه في المستقبل القريب أمام مأزق لا يستطيع الهروب منه؟ وهل فعلًا بناء المستوطنات يدل على تعافي الدّولة واستقطاب المهاجرين؟ خاصّة أنّ معركة طوفان الأقصى جاءت لتعمّق الصّراع والتّفاوت الطّبقيّ، والحرب الّتي أدّت إلى توقّف هجرة اليهود إلى فلسطين، حيث إنّ الهجرة باتت عكسيّة، بسبب الحرب، حيث تذكر مصادر يهوديّة أنه حوالي مليون يهوديّ غادروا فلسطين المحتلة إلى غير رجعة، فالأسباب الّتي أتوا من أجلها لم تعد موجودة الأمن والعمل، وتشير المصادر إلى أنّ من بين الّذين تركوا فلسطين المحتلّة سباب تم استدعاؤهم إلى التّجنيد، هذا عدا تدهور الوضع الاقتصاديّ حيث تشير التّقارير إلى أنّ ربع الإسرائيليين صاروا تحت خطّ الفقر، بالإضافة إلى أن الشّركات تأثرت، فـ 726 ألف شركة إسرائيليّة صغيرة وناشئة أغلقت منذ بدء الحرب، وتشير التّوقّعات إلى أنّه سيرتفع عدد الشّركات الّتي ستغلق أبوابها إلى 800 ألف شركة مع نهاية العام.
كما تراجعت الاستثمارات الأجنبيّة بنسبة 40 بالمائة من 25 مليار دولار عام 2023، إلى 15 مليار دولار في النّصف الأوّل من عام 2024، بحسب مواقع إلكترونيّة.
إذًا، نستدلّ، من خلال كلّ ما ذكرناه أنّ الأزّمة ستتفجّر بعد أن تنتهي الحرب، ولولا حرب 7 أكتوبر 2023 لكان ذلك الصّراع قد ظهر إلى العلن بوضوح.
[1] – (بالعبرية: מוֹשָׁב)، مصطلح عبريّ يشير إلى قريّة زراعيّة تكون فيه الأسر وحدات اقتصاديّة تدير قطعة الأرض بشكل خاصّ بها، وتعود ملكيّة أراضي (الموشاف) للصّندوق القوميّ اليهوديّ.
[2] – الشّرق الأوسط، رام الله، نُشر في 16 سبتمبر 2023م-20 ربيع الأوّل 1445 ه-.
[3] – الاستيطان، دولة فلسطين، وزارة الخارجيّة والمغتربين.
[4] – موقع الجزيرة.
[5] – الاستيطان يواجه تحدّيات ويفشل في مواجهتها، صحيفة الشّرق الأوسط، 28سبتمبر 2024 م- 25 ربيع الأوّل 1446 هـ.
[6] -الحرّة – واشنطن: 31 أكتوبر2023.
[7] – ضيف: البحث الأدبيّ، الطّبعة الثّانية، دار المعارف، مصر، 1976(ص.114).
[8] – الموسوعة الفلسطينية: القسم الثّاني- الدّراسات الخاصّة (في ستّة مجلّدات) المجلّد الخامس- الخطر الصّهيونيّ وحقوق شعب فلسطين- الدّكتور فايز صايغ ص.21.
[9] – موقع الجزيرة، 3\11\2023.
[10] -الاستيطان الإسرائيليّ في الأراضي العربيّة المحتلّة خلال حكومات نتنياهو(1)، عيسى فاضل النّزّال، مركز دراسات الوحدة العربيّة
[11]– الموسوعة الفلسطينية: القسم الثّاني- الدّراسات الخاصّة ( في ستّة مجلّدات) المجلّد الخامس- الخطر الصّهيونيّ وحقوق شعب فلسطين- الدّكتور فايز صايغ ص.29.
[12] – مواقع إلكترونيّة.
[13] -معهد الأبحاث التّطبيقيّة- القدس (أريج)، بالتّعاون مع معهد أبحاث السّياسات (ماس)، آذار2023، ص. 3.
[14] -الاستيطان، “دولة فلسطين- وزارة الخارجية والمغتربين”.
[15] – الآثار الاقتصاديّة لاتّفاقيّة كامب دايفيد، معتصم عدوان، مجلّة البيان، العدد 378.
[16] – خالد عابد، محصّلة الاستيطان منذ اتّفاق أوسلو ونُذُر 1995، مجلة الدّراسات الفلسطينية، العدد 21، شتاء 1995.
[17] – المستوطنون تضاعفوا سبع مرات منذ اتفاق أوسلو، صحيفة الشّرق الأوسط، سبتمبر 2023 م 1445 ربيع الأوّل.
[18] – أحمد حنيطي، الأغوار الفلسطينيّة، الواقع ومآلات المستقبل، مجلة الدراسات الفلسطينية، سنة 2024.
[19] – كلمة تركية آتية من الكلمة اللاتينة (طوبوغراف) أي تضاريس الأرض .وتأتي بمعنى بناية العقارات.