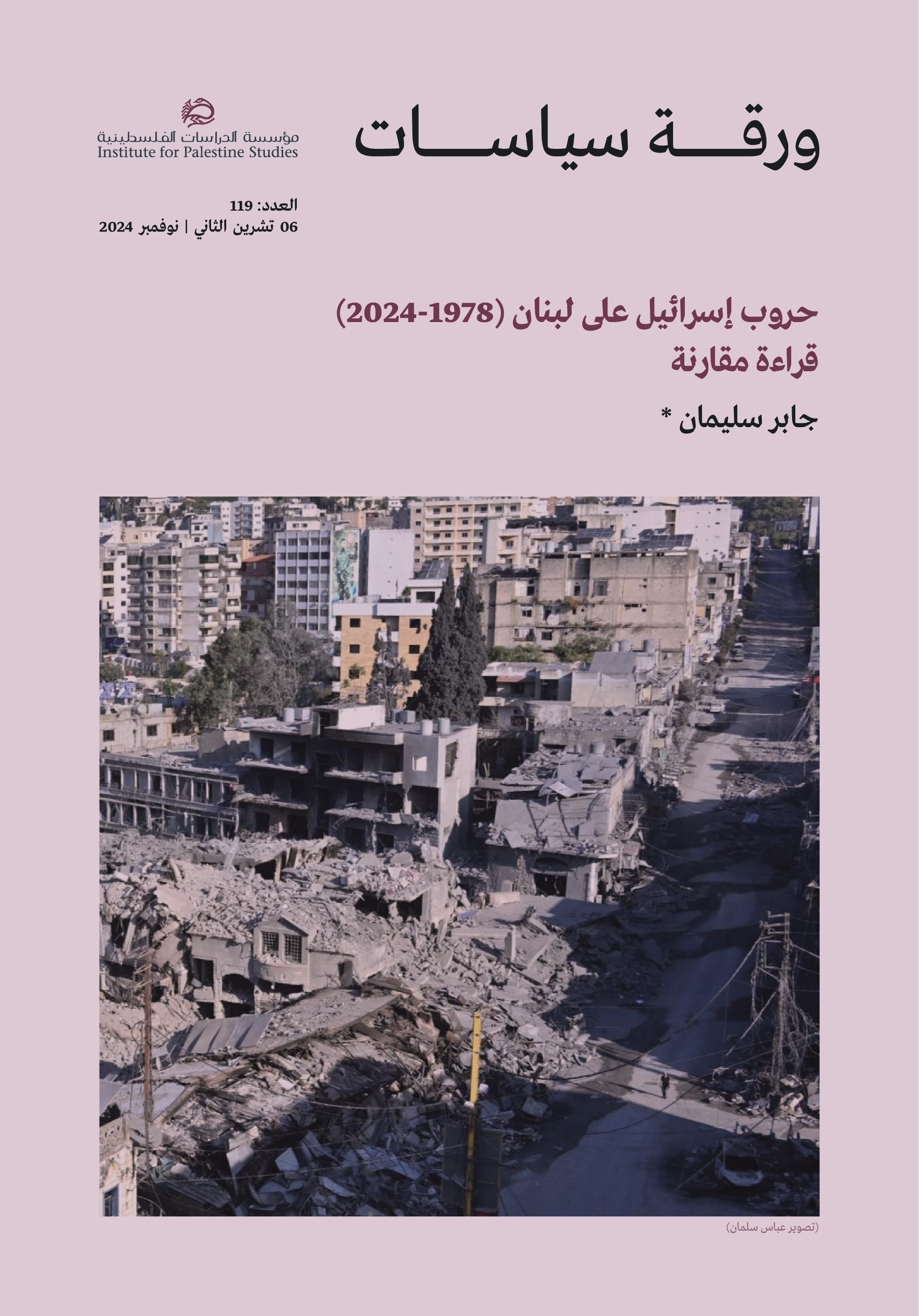وليد عبد الرحيم قال كلمته ورحل


الأخبار- أيهم السهلي
جرّب كل شيء في الفنون تقريباً، كتب الشعر والرواية والقصة القصيرة وسيناريو الأفلام والموسيقى، وأخرج عدداً من الأفلام السينمائية والوثائقية، وكتب في الصحافة الفلسطينية والعربية، وأصدر نحو 21 كتاباً. هكذا كان وليد عبد الرحيم، الذي يطيب لي أن أصفه بالرجل المكافح والمثابر والباحث عن معنى أو معانٍ جديدة له في كل شيء يجربه، كما كان في كل شيء يبحث عن فلسطينه في وعي الفدائي الذي كانه في ثمانينيات القرن الماضي مع البندقية، والذي ظل يحاول الحفاظ عليه مع القلم والكاميرا حتى آخر يوم في عمره يوم 12 شباط الجاري.عرفته منذ سنوات طويلة، كنت صغيراً أخطو أولى خطواتي في الكتابة، زرته أول مرة رفقة صديقة بمكتب له في دمشق، كان قد افتتحه كشركة إنتاج فني، وقابلته مرات عدة في اتحاد الكتاب والصحافيين الفلسطينيين في شارع بغداد وسط العاصمة السورية، وفي كثير من الفعاليات، وفي كل مقابلة معه، كان محيطاً أو محاطاً بجمع من الأصدقاء يتبادل معهم الحديث حول مسألة ما في الوضع الفلسطيني السياسي أو الثقافي.
منذ نحو سنة ونصف، وهو مواظب على الكتابة على صفحات هذه الجريدة، لم يكتب سوى عن فلسطين، همه اليومي والأبدي، شغله الشاغل في مختلف أنواع الفنون التي جرّبها واختبر نفسه بها. وفي مقالاته التي نُشرت في معظمها في ملحق «البلاد» الذي تصدره «الأخبار» كملحق فلسطيني، كانت مقالاته في الغالب ناقدة للوضع الراهن، متألمة وباكية أحياناً من الذي آلت إليه أحوال فلسطين وشعبها. لكنه خلال الحرب الضروس التي تُشن على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، غيّر في وجهة كتابته، وإن حافظ على النفس النقدي، ولكنه التفت إلى ما يجمع، إلى ما يمكن البناء عليه، فكتب في مقالة له، عن البعد العربي لفلسطين: «كنت قد خرجت للتوّ من استديو بث تلفزيوني مباشر، وقد نسيت وشاح فلسطين على كتفي، وهبطت من سيارتي القديمة لأشمّ رائحة الذرة المنتشرة ببخارها، كأنها متضامنة مع حس الغضب الشعبي مما يجري في فلسطين… للبخار أيضاً معناه البليغ! انتقيت عرنوس ذرة، وقد كنت جائعاً، لذا بدأت بالتهامه سريعاً، وسألت عن ثمنه. ردّ البائع ذو اللهجة الدمشقية الفاقعة بقوله: لست نذلاً لآخذ من رجل وضع علم فلسطين على رقبته! قلت يا رجل هذه مسألة أخرى، أرجوك، فأصرّ وحلف بالطلاق على زوجتيه الاثنتين بأنّه لن يأخذ ثمن الذرة، ثم رفع يديه نحو السماء داعياً الله أن يثبت أقدام شعب فدائيي فلسطين، وينصرهم ويسحق القتلة المجرمين الصهاينة والغرب والعملاء (…) ابتعدت فناداني: أستاذ! التفت إليه، “لازم تعرف إنو القنبلة الذرية رموها بالتقسيط على إخوتنا هناك، فلا خوف من أخرى”، وخرجت من صدره عبارة: “الله على الظالم”. بالنسبة إليّ، كانت تلك إشارات عميقة بليغة وراسخة كوتدٍ في وجدان العربي البسيط الذي لم تدنّسه السياسة ووسائل الإعلام العربي المتصهين». كان هذا الحدث في دمشق، حيث قضى وليد معظم حياته، هو وزوجته وبناته الثلاث. وحيث عرف معظم أصدقائه الكثر، الذين كان يجمعهم ويجتمع بهم في استديو في منطقة جرمانا بريف دمشق، يتحدثون في شؤون شتى، ويعزف لهم بعض ما يعرف من الألحان، فيغنّون ويضحكون، لينفضّ الصحب كل إلى بيته، ولعل من الدراما في الرثاء أن تنتهي العبارة السابقة، بجملة «ويبقى وليد وحيداً»، ولكن للدقة، لم يكن هذا الرجل وحيداً، فهو دائم اللقاءات، ودائم الاستعداد للتعرف إلى الآخرين، كما أنه دائم الاستعداد للبدء بمشاريع جديدة، يبني لها عظماً ولحماً، وغالباً ما يباشر بها. هكذا كان وليد عبد الرحيم الراحل الذي ستُستعاد ذكراه دائماً بين صحبه في دمشق ولبنان.
عرفت وليد، وعرفت من صحبه، ولا بد لكل من عرفه، أن يسرد قصة عنه، وفي واحدة من الطرائف الجميلة عنه، أنه تعلم من صديقه العزف على آلة الغيتار، وكلمة تعلّم هنا لا تفيد بأنه تلقّى عدة دروس، بضعة دروس قليلة ليس أكثر، يحدّثني صديقنا المشترك عن الحكاية، وقد كان هو الذي علّمه. عاد إليه بعد مدة قصيرة، فوجده يدندن على آلته الموسيقية، ولكنه لم يكن يجرب عزف مقطوعة معروفة، أبداً، كان وليد يجرب التلحين. يبتسم الصديق المشترك بمحبة، وأبتسم معه. وأفهم من هذه الحكاية، ومثلها حكايات، أن وليد عبد الرحيم، لم يكن مجرد مجرب في الفنون، بل كان مغامراً، لا يدخل بقاموسه كلمة «المستحيل»، فقاموسه مبنيّ على المحاولة والعمل والوصول إلى النتائج، حتى لو لم تكن على مستوى رضاه، ولكنه كان بارعاً في بذل الاهتمام بمنتجه، وهو ما نسميه عادة بالشخص المجتهد. وكان واضحاً في نسج العلاقة بين نفسه وبين منتجه الإبداعي من جهة وبين المتلقي من جهة أخرى أو من الجهة نفسها، حين يورطه بلعبة التجريب خاصته، فمثلاً في مقدمة روايته «لست حيواناً» الصادرة عن دار «دلمون الجديدة» في العام الماضي كتب منوهاً: «أرجو من كل قارئ عدم تناول هذه الرواية بعين تستبق احتمالات شكلها أو مضمونها، فقد ارتكبت شخصياً في السابق هذا الخطأ أثناء بعض قراءاتي (…) ليس المقصود من هذه الكلمات توجيه كيفية تناول النص، أو الهيمنة على آلية التلقي(…) لذا، فإنك أيها القارئ النبيه إن أنت قرأت مـا سـوف يـلـي مـن صفحات بناء على الشكل الروائي المعهود، أضمن لك بأنك قد تـرى روايتي هذه مجرد كلمات سخيفة، لهذا اقتضى الأمر الإشارة (…) هي في النهاية محض رواية ما، قد تستحقّ القراءة، وها أنت ذا مرة أخرى قد وفّقت أو خُدعت باقتنائها، ولا مفرّ لك، فالمسألة ذاتها سوف تحدث معك مراراً وإلى الأبد، لأن هذا ما سُمي مراراً بـ ورطة القراءة». وعلى ذلك فقراءة وليد عبد الرحيم، والدخول في تفاصيله، توريطة جميلة، أدعوك إليها عزيزي القارئ.
أخيراً، ربما الفنان والفلسطيني جداً وليد عبد الرحيم كان يبحث عن بعض الشهرة التي يستحقها، ربما لأنه كان يعرف أن الناس لن تذكره إلا في رحيله، أو بعد رحيله بسنوات. وجميل من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أنها نعته «باسم أمينها العام ونائبه ومكتبها السياسي ولجنتها المركزية»، فقد كان «عضو أكاديمية دار الثقافة والمكتب الإعلامي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ومركز الهدف في سوريا، وعضو الاتحاد العام للكتاب والصحافيين الفلسطينيين فرع دمشق، أحد أعلام الفكر والثقافة والفن الفلسطيني والعربي».
رحل وليد عبد الرحيم، عن 60 عاماً، وهو يأمل في العودة إلى نحف قضاء عكا، رحل وقد جرب الفنون جميعها، لكن الموت الذي تربّصه في المرض العضال، هزمه أخيراً، بعد أن قاومه لسنتين تقريباً بالإرادة والكتابة عن مرضه.